ملكوت وكنيسة.
صفحة 1 من اصل 1
 ملكوت وكنيسة.
ملكوت وكنيسة.
ملكوت وكنيسة.
إنّ كلاًّ منّا مدعوّ إلى أن يعود إلى طريقة عيش يسوع محاولاً أن يعتنقها بقوّة في التأمّل والصلاة. لم يتكلّم يسوع في تعليمه على مؤسّسة بشريّة, بل تكلّم مراراً وتكراراً على ملكوت الله, وكأنّه ما شاء أن يقيّد عمله الفدائيّ, منذ البداية, في ما يشبه "التوراة والهيكل", وكأنّ في قصده أن يستبدلها أو ينقضها. ولو أنّه فعل, لَقَتَلَه اليهود في بدء رسالته.
أتى مخلّصاً إيّاهم والبشريّة جمعاء, وكان هو الذي بشّر به الأنبياء. بيد أنّ طول الزمن وانحراف الناس نحو ما يُرضي تطلّعاتهم البشريّة, جعلهم لا ينتظرون مخلّصا بحسب تعاليم الأنبياء وحسب, بل زعيماً سياسيّاً أو قائداً عسكريّاً يرفع عن كاهلهم نير الاحتلال, ويحمل إليهم التّقدّم والإزدهار.
فالتطويبات التي أطلقها يسوع من على الجبل في الجليل, والتي فيها نادى بالفقر والوداعة والرحمة, وأشاد بأولئك الذين يتقبّلون الآلام والاضطهادات على أنواعها, إنّما هي بعيدة كلّ البعد عن حقيقة المخلّص الذي كانوا يريدون.
وبعيداً كذلك عن آذانهم قوله إنّ الدخول في الملكوت, شأنه شأن الإنتماء إلى الكنيسة, يُحتّم على المرء أن يعيش في حال من الطهر والبساطة والثقة بالله, والتوكّل على محبّته اللامتناهية, والصفاء في محبّة الناس, ممّا يجعل في قلبه سلاماً يُشعره بأنّه يعيش في سماء, وهو ما زال في عِداد سكّان هذه الأرض. وأقرب مَنْ جسّدَ تلك الحال في ذهنه أطفال كان لهم في قلبه مقام خاصّ. ونحن نذكر أنّه, عندما أزعج ضجيج الأطفال التلاميذ يوماً, وظنّوا خطأً أنّ ذلك يُزعج المعلّم أيضاً, قال لهم: "دعوا الأطفال يأتون إليّ ولا تمنعوهم, لأنّ لمثل هؤلاء ملكوت السموات". ولكي يزيد في توضيح الأمر, قال لهم أيضاً: "إن لم تعودوا كالأطفال, لن تدخلوا ملكوت الله".
لكنّ يسوع المُخلّص ما أتى ليعمل إرادة الناس ولا ليرضي نزواتهم, بل لتتميم إرادة أبيه الذي في السماء. لِذا سار في نهجه, حتّى النهاية, مُهيّـئاً شيئاً فشيئاً, جماعة آمنت بمبادئه, تلك المبادئ التي ستتحوّل, مع الزمن, وبتوجيه من الروح, صخوراً صلبة تكوّن الأساس المتين لكنيسته. وكان يُدركُ آنذاك أنّ كنيسته سوف تمُرّ, كما في المؤسّسات جميعها, بالكثير من التجارب الصعبة, وتتحمّل الاضطهادات والآلام, وتكويها نيران الإنقسامات, وتتجاذبهاالإعتبارات البشريّة, ويُشوّه نقاءها أحياناً ما كان يخشاه عندما دعا تلاميذه إليه وقال لهم: "تعلمون أنّ رؤساء الأمم يسودونها, وأنّ أكابرها يتسلّطون عليها. فلا يكن هذا فيكم, بل مَن أراد أن يكون كبيراً فيكم, فليكن لكم خادماً. ومَن أراد أنْ يكون الأول فيكم, فليكن لكم عبداً. هكذا ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدَم, بل ليَخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس".
ولكن, إلى جانب ذلك كلّه, كان يُدركُ أيضاً أنّ أعداداً وافرة من أبناء كنيسته سيتميّزون بروح الخدمة تلك وسيبذلون حياتهم, كما فعل هو, ليشهدوا أمام الناس للنهج الذي عليه أسّس الكنيسة, ويسيروا في الطريق التي أخاطها لتلاميذه وأوضحها لهم بقوله: "مَن أراد أنّ يتبعني, فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني, لأنّ الذي يريد أن يُخلّص حياته يفقدها, وأمّا الذي يفقد حياته في سبيلي فيجدها".
في كنف القدّيسين والشهداء, وتحت أعباء ضعف الكنيسة وما يجرّ ذلك الضعف من شرور وويلات, تتابع الكنيسة مسيرتها بثقة, سائرة على خطى المعلّم في أكمال عمل الخلاص, لأنّه هو الذي يسير فيها ومعها, بحسب الوعد الذي قطعه لتلاميذه عندما أرسلهم ليُتلمذوا ويُعمّدوا قائلاً لهم: "هاأنذا معكم طوال الأيّام إلى نهاية العالم".
لقد كتب إرنست رينان, وهو طالما اشتهر بشكّه في أمور الدين, قائلاً: "يبدو المسيح اليوم, وبعد أن انقضى على مروره في هذه الدنيا مئات السنين, أنّ حبّه للعالم أصبح ألف مرّة أكثر وضوحاً عمّا كان في أثناء حياته على الأرض. لذلك فإنّ حبّ العالم له قد زاد آلاف الأضعاف منذ تلك الفترة. وقد غدا حقّاً حجر الزاوية للبشريّة بأسرها, حتّى ولو أنّه حدث أن زال ذكره في الدنيا, وزال معه كلّ ما ارتبط في شخصه, ليتزعزع الكون بأسره, حتّى عمق أعماق أساساته". وهذا بالطّبع أمر لا يُمكن لمُخيّلة أن تتصوّر حدوثه. فكفرناحوم باقية إلى ما لا نهاية, وكذلك أيضاً نائين وبيت عنيا والقبر الفارغ واللفائف التي غدت علامة الإنتصار على الموت إلى الأبد.
وسيكون هنالك دوماً مريض ينال الشفاء, وأعمى يعود إليه بصره, وإنسان أثقل كاهله الشعور بالذنب يحسّ بالغفران وينطلق في الحياة مجدّداً. وكلّ ذلك من خلال لمسة يد مُحِبّة ونظرة تفيض حناناً من ذلك القلب الذي أُفعِمَ حُبّاً لا يعرف أيّة حدود.
وهذه كلّها أشعّة ما زالت تتدفّق في ربوع عالمنا مُنبثقة من تلك المنارة التي عُمرها من عمر تاريخ البشر, والتي اكتمل الإشعاع فيها منذ ألفيّ سنة في يسوع المسيح المخلّص. وعندما "تُظلم الشمس, والقمر لا يُرسل ضوءه, وتتساقط النجوم من السماء...", ويؤخذ الناس على حين غفلة, عندما يحدث ذلك في يوم لا يعرفه أحد ولا الإبن إلا الآب, سيكون إشعاع ذلك النور أسطع من الشمس والقمر والنجوم مجتمعة.
فآخر إنسان في آخر يوم من عمر الكون, سينعمُ بدفء ذلك النور الذي أشرق في الظلمات, والظلمات لم تدركه". ولكن شرط أن يفتح ذلك الشخص قلبه للنور "ولا يُفضّل الظلام عليه". آنذاك يستنير سبيله. "أنا نور العالم, من يتبعني لا يمشِ في الظلام, بل يكون له نور الحياة".
سيأتي يوم يجد فيه كلّ منّا نفسه سالكاً تلك الطريق التي لا بدّ وأن يمرّ فيها كلّ إنسان. وآنذاك سيظهر ذاك "النور" على حقيقته, وهو جالسٌ على عرش مجده, سيّداً يُرحّبُ بالخراف الذين عن يمينه, ذلك لأنهم عرفوا كيف يرحّبوا هم بالجائع والعطشان والغريب, وقد اتّسع وقتهم وقلبهم للمريض وللمسجون ولكلّ مهمّش. وهُم فعلوا ذلك من دون أن يُدركوا أنّ في المريض والغريب والمُهمّش والمسجون يكمن ذاك الوجه المنير الذي يحسّ أنّك كلّما صنعت شيئاً لواحد من هؤلاء فله هو صنَعت ذلك, إذ إنّ كلاً منهم يحمل في عمق نفسه صورة لوجه الله, بل يحمل الله ذاته...
تعال الآن نعود معاً إلى كفرناحوم ونائين وبيت عنيا, حيث التقينا النور, بل مصدر كلّ نور وحياة. إنّ من جزم في نفسه أن يتقرّب من يسوع المسيح, ليتعرّف إليه عن كثب, إنّما يضع نفسه أمام تحدّ عظيم. والمهمّة التي انتقاها لنفسه لن تكون يوماً سهلة. ذلك أن يسوع المسيح ما وعد محبّيه يوماً إلا بصليب, عليهم أن يحملوه, وهو على مثال صليبه, لن يكون خفيفاً. بيد أنّه, كما وجد هو مَن يُساعده في حمل صليبه, سيرسل دوماً إلينا مَن يمُدّ يد العون في ساعات الشدّة.
والتّعرّف إلى المسيح يتطلّب, أول ما يتطلّب, أن أكرّس له ما يكفي من الوقت, فاقرأ الكتاب وأصغي في التأمل والصلاة, إلى ما يقوله لي الروح عن المسيح وعن ذاتي, وعن المعنى الذي يمكنني أن أعطيه حياتي.
الوقت الذي أمضيه في التأمّل والصلاة هو ما يجعلني أختبر قوّة الروح فيّ, وعمل الله في حياتي, وقتٌ لأقرأ وأصغي وأحبّ, فأحيا وأجد في الله راحة لنفسي.
كم هو مهمّ أن أعود بقلبي التعب إلى حضن المسيح, وأجلس معه على الجبل وهو يُكثِّرُ الخبز والسمك, لتكون لي قوّة فيه كما للجموع, وأن أقف وإيّاه على بئر يعقوب وأصغي إليه يحدّثني والسامريّة عن "الماء الحي". وكم هو حسنٌ أن أشارك لعازر ومرتا ومريم في فرحة الانبعاث والانطلاقة في الحياة مجدّداً.
وفوق كلّ شيء, عليّ أن أقف على أقدام الصليب, تلك الخشبة التي تمّ فداء الكون عليها, وأن أنتظر في البستان مع المجدليّة فجر القيامة. وأنت تقرأ هذه الفقرات, ها إنّ عقارب الساعة التي في معصمك, أو تلك المعلّقة على الحائط في بيتك, تتقدّم بانتظام, وعلى بابك يقف غريبٌ ويقرع, إنّه يحاول أن يدخل... وهو يُدركُ الآن أنّك تصغي.
إذا كان من المهمّ أن أتعرّف إلى المسيح من خلال ما كَتَبَت عنه الأناجيل, وما قال فيه الآباء والكنيسة, فمن المهمّ أيضاً أن ألتقيه اليوم حيث أعيش وأعمل. فملكوت الله جزء لا يتجزّأ في حياتي وعملي, بل هو "في داخلي". يُبنى الملكوت ويرتفع بقدر ما يعرف المرء كيف يعيش في شراكة حبّ فاعل مع المسيح ومع إخوته. وإنّ هذا لكنز ليس كالكنوز التي يجمعها الناس, والتي هي إلى فناء, وقد تُسرق منّا في أيّة لحظة. فالملكوت أشبه بكنز يتطلّب الاهتمام به جهداً مُكلفاً. فمًن وجَدَهُ لا بدّ وأن يضحّي بكلّ شيء كي يحافظ عليه وينمّيه, لأنّه أثمن من كلّ شيء.
"لا تكنزوا لأنفسكم كنوزاً في الأرض, حيث يفسد السوس والعثّ, وينقّب السارقون فيسرقون, بل اكنزوا لأنفسكم كنوزاً في السماء, حيث لا يفسد السوس والعثّ, ولا ينقّب السارقون فيسرقوا. فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك".
ها هو الملكوت فيما بيننا يدعونا إلى أن نحبّ ما هو أبعد, ونجهد في سبيل ما هو "أبقى" وأثمن. إنّه نعمة من الله وحياة. لقد كان دائماً وما زال يحتضن في طيّاته سرّ الحياة والموت, إذ إنّ فيه تأخذ الحياة, كما الموت, معناهما.
إنّ الملكوت حيّ في كلّ مدينة وفي كلّ قرية, بل وفي كلّ بيت ينبض الحبّ في قلوب ساكنيه. وهو قائم أيضاًفي قلبِ مَن لا بيت له ولا مأوى, إنّه النور الذي يخترق حياة الناس حتّى في أعمق أعماق بؤسها.
والملكوت يتخطّى الزمان والمكان, فحيث إنسان يحتضن المسيح في قلبه, وحيث بَشَر يسيرون على نهجه, وأناس يرقصون على أنغام موسيقاه, فهناك الملكوت.
لقد واجه يسوع الكثير من المصاعب والمضايقات وعدم الإيمان, حتى من أقرب المقرّبين إليه أحياناً. ولكنّه, بكلّ ثبات وطول أناة, راح يُعلّم ويشفي. وهكذا كان يبني كلّ يوم, حجراً فوق حجر, إلى أن غدا واضحاً أنّه أتى يؤسّس نهجاً جديداً, طريقة عيش جديدة, وهو يُعبّد طريقاً جديدة للخلاص. إنّه أتى ليُتمّم بناء الملكوت.
في البدء كان تصميم البناء أشبه بمخطّط يفتقر إلى الوضوح. فاليهود رأوا أنّ التوراة هي كلّ شيء, وأتى الكتبة والفرّيسيّون ففرضوا العمل بها بروح من الكبرياء جعلتهم يتمسّكون بالحرف ويهملون في الغالب ما في الجوهر. فأتى كلام يسوع إليهم غاية في القسوة, ناعتاً إيّاهم "بالقبور المكلّسة" و"بالحيّات أولاد الأفاعي..". وما كان بإمكانهم أن يتصوّروا أنّ ابن نجّار من الناصرة يمكن أن يكون المخلّص. لقد حسموا الأمر وأصدروا عليه وعلى كلّ من أبناء بلدته حكماً مسبقاً يقضي بألاّ "يخرج من الناصرة شيء صالح". لقد كانت قلوبهم من طينة غير التي جُبِلَ منها قلب تلك السامريّة التي كانوا بلا شكّ يحتقرونها, ولو أنّها من بنات قومهم لرجموها أقلّه خمس مرّات.
كانوا يحلمون بمخلص يليق بكبريائهم ويلبّي طموحاتهم, مخلّص سيفه ماضٍ, ورمحه ثاقب, وهو يحسن قيادة الجيوش الجرّارة التي ستعيد الحكم إلى إسرائيل. ونسوا ما قاله فيه أشعيا على أنّه سيكون ملك سلام لا ملك حرب, وفي عهده "سيربض الذئب مع الحمل...".
ما كان بإمكانهم أن يقبلوا مسيحاً فقيراً, أتى "ليَخدِم لا ليُخدَم", "يأكل مع العشارين والخطأة", يوصي مَن يصغون إليه بأنّ "أحبّوا أعداءكم, وأحسنوا إلى مبغضيكم, وباركوا لاعنيكم, وصلّوا من أجل المفترين الكذب عليكم. مَن ضربكَ على خدّكَ فاعرض له الآخر...".
ويسوع ما بدأ عمله بخلق مؤسّسة ذات تنظيم محكم, لها أركانها وفروعها وأنظمتها, بل بدأ عمله مع حفنة من الرجال, ليسوا من كبار هذا العالم, ولا هم في نظر الناس, من طبقة مميّزة. وقال بولس فيهم إنّ الله اختار الجهّال والضعفاء ومَن شابههم, لكي يُدرك الجميع أنّ بناء الملكوت إنّما هو عمل الله قبل أن يكون نتيجة لجهد بشر, وهو يبدأ متواضعاً ويكبر. هذا يذكّرنا به مَثَل حبّة الخردل حيث قال: "مثل ملكوت السموات كَمَثل حبّة خردل, أخذها رجل فزرعها في حقله, وهي أصغر البذور كلّها, فإذا نَمَت كانت أكبر البقول, بل صارت شجرة حتّى أنّ طيور السماء تأتي فتعشعش في أغصانها".
لقد نما الملكوت شيئاً فشيئاً وكان العاملون في بنائه أشبه بالخمير في العجين, والكنز المخبّأ في حقل. وكأنّ يسوع أراد أن يسير في عمله بتواضع وبشيء من الصمت, لأنّ أهمّ ما في الأمر التطور الداخلي عند الذين التزموا به, بعيداً عن المظاهر والشكليّات, معلناً أنّه "يريد رحمةً لا ذبيحة, وأنّ السبت خُلِقَ للإنسان, لا الإنسان للسبت...".
وهكذا ببطء, ولكن بعمق, كان الملكوت يُبنى وتمتدّ أشعّته فتنتشر أحيانا وتنحسر أحيانا أخرى, حتّى أنّه, عندما صُلب يسوع بدا لبعضهم وكأنّه لا يتعدّى كونه شيعة من الشيع التي سوف تندثر بموت صاحبها.
والواقع أنّ الأمور سوف تتبدّل تماماً ولكن في اتجاه آخر. ذلك أنّ الجلجلة, بَدَلَ أن تكون النهاية, غدت مدخل عهد شفى جرح آدم الأول, وشرّع أمام البشريّة أبواب السماء مجدّداً.
ولكي يكتمل عمل الخلاص بين الناس, كان من الضروريّ أن يستمرّ حضور المسيح القائم من الموت في إطار يمكّن أولئكَ الذين تتلمذوا على يده, وشهدوا على حقيقة قيامته, من أن يُتابعوا العمل باسمه. لقد شاء أن يستمرّ حضوره معهم من خلال ما أعطاهم في الليلة التي أُسلم فيها, وقد أعطاهم ذاته ليكون لهم خبز حياة, يبقى معهم "حتّى انتهاء العالم". ذلك لأنّه أرادهم, وكلّ مَن سيؤمنون على أيديهم, أن يُعلنوا باسمه "التوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم, ابتداء من أورشليم", كما أرادهم أن يكونوا "شهوداً على تلك الأمور...". ولكي يقووا على إكمال المسيرة قال لهم: "إنّي أرسل إليكم ما وعد به أبي. فامكثوا أنتم في المدينة إلى أن تلبسوا قوّة من العلى". وهكذا فعلوا وحلّ الروح القدس عليهم, إذ "كانوا كلّهم مجتمعين في مكان واحد, فانطلق من السماء بغتة دويّ كريح عاصفة, فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه, وظهرت ألسنة كأنها من نار قد انقسمت, فوقفت على كلّ منهم, وامتلأوا جميعاً من الروح القدس, وأخذوا يتكلّمون بلغات غير لغتهم, على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلّموا". وإذا كان لنا أن نبحث عن حدث الروح القدس يكون هو الحدث.
عندما تبدأ المؤسّسة تظهر إلى العيان في جماعة بشريّة, يُصبح من الضروريّ أن يُقام تنظيم لتلك الجماعة. ولا بُدّ أنّ التلاميذ وبطرس, وهم في العنصرة, تذكّروا المشهد التالي الذي حدث في نواحي قيصريّة فيلبّس حيث "سأل يسوع تلاميذه: مَن يكون ابن الإنسان في قول الناس؟...", وبعد أن أجابوا طرح عليهم السؤال بشكل شخصيّ قائلا: "مَن أنا في قولكم أنتم ؟", فأجاب سمعان بطرس: "أنت المسيح ابن الله الحيّ".
وبعد شهادة بطرس هذه بلاهوت يسوع, وذلك بوحي مِن لدن الآب السماويّ, قال له يسوع بكلّ وضوح ما لم يقله لسواه من التلاميذ: "أنا أقول لك: أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي, فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. كلّ ما تربطه في الأرض يُربط في السموات, وما تحلّه في الأرض يُحلّ في السموات".
يرمز الصخر إلى الصلابة والثبات, وهذا لقب بطرس منذ ذلك الحين.
وتشير الكنيسة إلى الجماعة الجديدة التي أسّسها يسوع وجعل بطرس رمز الثبات فيها, وعهد إليه بدور رفيع في السهر على انطلاقتها. ومن ضمن هذا الدور قبول الناس في الجماعة أو عدم قبولهم, وتفسير كلام يسوع على حقيقته. وهذه السلطة لم يحصرها ببطرس, بل أعطاها أيضا إلى سائر التلاميذ معه, ولو كانت له الأولويّة عليهم.
فها هي الجماعة تبدأ بالظهور وكأنّ لها بداية بُنية تنظيميّة مُرتكزة على بطرس والأحد عشر. لذا نراهم, بعد حلول الروح القدس مباشرة, يقفون معاً, ونرى بطرس يتكلّم باسمهم بوضوح, وكمَن له سلطان: "فوقف بطرس مع الأحد عشر, فرفع صوته وكلّم الناس قائلا: يا رجال اليهوديّة, وأنتم أيّها المقيمون في أورشليم جميعاً, اعلموا هذا, واصغوا...". وراح يُذكّرهم بما تنبّأ به النبيّ يوئيل عمّا يتحقّق الآن... تمّ انتقل إلى الكلام على "بني إسرائيل" جميعاً فذكّرهم أيضاً بموت يسوع وقيامته, موضحاً لهم أنّ ما حدث كان قد تنبّأ به النبيّ داود من قبل أيضاً.
سيحيا هذا الحدث إلى ما لا نهاية في الكنيسة. ومشاركة الإنسان لله في حياته, هي التي تُحيي الإنسان المؤمن من خلال الكنيسة. ومن خلال الكنيسة أيضاً سيحصل الأنسان على الغفران حين يفشل في العمل مع الله لبناء ملكوته. فعطاءات الله للإنسان لا تُقدّر, بل توصف "بالحياة الوافرة", بيد أنّه على الإنسان أن يُقبل على ذلك النبع ليستقي منه القدرة وملء الحياة, والغفران أيضاً.
تفيض الحياة من قلب الله, ولكنّ الإنسان لا يتلقّاها من فراغ, من الهواء الذي يُحيط به, ولا من أمور نتصوّر وجودها في مخيّلتنا, بل يستقيها من خلال أقنية محدّدة تمرّ كلّها في يسوع المسيح الذي هو صورة الله وقدرته الفائقة.
وهو ما تحاول الكنيسة أن تجسّده في واقعها وفي سلوكها, جاهدة في أن تدعه يملكها كجماعة من دون أن تملكه هي وتستأثر به.
يتعامل الله معنا, بل يعمل فينا, من خلال واقعنا كبشر. وسرّ نفسيّتي كإنسان ليس بسرّ عليه. فحقيقة المسيح, كما حاجات البشر, بل حياتهم بأكملها, هي من العوامل التي يمكن أن تُبيّن لنا هدف يسوع من تأسيس كنيسة ليحقّق من خلالها ملكوت أبيه في العالم.
يسوع, ذاك الغريب الذي يقرع بابك وبابي وكلّ باب في الدنيا, أتى ليعايش مَن يُقرّر أن يفتح له بابه, ويوضح له حقيقة حضور الله في حياته, ذلك الحضور الذي تجسّد في حدث الخلاص, من ولادة المسيح إلى قيامته, والذي سوف يتجسّد في حياة كلّ مَن يصغي إليه ويقبله فادياً ومخلّصاً.
هذا الحضور نفسه, تحاول الكنيسة أن تجسّده بدورها. وشاء يسوع أن يتماهى معها بعد أن أوحى إليها حيقته في تعاليمه. وهو يجدّد حضوره فيها من خلال لقاءاته المتكرّرة في علامات حسّية ترافقنا في مراحل حياتنا كافّة, وتسمّيها الكنيسة "أسراراً".
وتعاليم يسوع تلك التي أعطاها تلاميذه أرادها أن تنتشر من خلالهم في العالم كلّه. فبعدما قام من الموت وراح يتراءى لهم الواحد تلوَ الآخر, أفراداً وجماعات, قال لهم: "إذهبوا في العالم كلّه, واعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين...". وأعطاهم أيضاً, مع كلمته, مواهب الشفاء. فهو أرادهم أن يسلكوا, كما سلك هو في حياته, مُحقّقاً رسالته المزدوجة, رسالة التعليم ورسالة الشفاء, فهو من أجل ذلك أتى إلى العالم متجسّداً.
لذا كان من الطبيعيّ, لمّا راحت الكنيسة تنتشر في أماكن بعيدة, أن يبدأ العارفون بتلك الأمور بكتابة ولو بعض منها, بوحي من الروح القدس.
وهكذا تكوّن, بعد عشرات السنين على موته, ما نسمّيه اليوم بالأناجيل الأربعة التي هي لمتّى ومرقس ولوقا ويوحنّا.
ولكن هذه الكتب هي, منذ ذلك الحين, في عُهدة الكنيسة التي هي أمّ ومعلّمة. فهي تشرحها وتوضح ما قد يصعب فهمه فيها. فالكنيسة هي التي تسلّمت من يسوع رسالة التعليم, ولم تتسلّم منه أيّة نصوص مكتوبة. لقد شاء أن تكون الكنيسة امتداداً لشخصه ولرسالته. وهكذا يمكننا أن نفهم السؤال الذي وجّهه إلى شاول عندما التقاه وهو في طريقه إلى دمشق قاصداً إعتقال أتباع يسوع وسوقهم إلى أورشليم: "شاول شاول, لماذا تضطهدني ؟".
ولأنّ يسوع أراد الكنيسة امتداداً لشخصه ولرسالته, بل جسده السّريّ, تؤمن الكنيسة بأنّ الروح يعضد ضعفها دوماً ويُنير طريقها لأنّها منذ البداية سمعت صوت المعلّم وما زالت تسير على هديه: "كما أرسلني الآب... هكذا أنا أرسلكم".
أرسلهم, ولكنّه كان يُدرك أنّه قد "اختار مَن هم ضعفاء ليخزي الأقوياء". إثنا عشر رجلاً دعاهم وأرسلهم ليحملوا الرسالة إلى العالم كلّه, ووعدهم بأن يكون دوماً إلى جانبهم في عملهم.
ولكن, لا ننسَ أنّ هؤلاء كانوا بشراً متسربلين بالضعف ككل البشر, ولكنّ قوّتهم هي في الذي أرسلهم والذي يعيش معهم وفيهم.
وإذا كان المسيح حيّاً في كنيسته اليوم وهو الله, إذا يمكن الكنيسة أن تدّعي بأن الله ليس في أساسها وحسب, بل هو أيضاً في تاريخها, في كلّ مسيرتها التاريخيّة. لا تبعد الكنيسة عن المسيح مسافة ألفي سنة, لأنّه ما فارقها يوماً, لأنّها هي تجسّد له, وهي تفقد هويّتها إذا ما غُيّب المسيح عنها.
لذلك يقال عن الكنيسة أنّها مقدّسة وإنّ نموّها لا يخضع لقوانين بشريّة... والمسيح الحيّ في كنيسته يجترح العجائب كلّ يوم في نفوس الناس, معزّياً بعضهم ومشجّعاً بعضهم الآخر, ومضرماً الحبّ في قلوب آخرين, الذين يقولون مع بولس: "إنّ حُبّ الله هو الذي يدفع بي إلى الأمام".
يُريح المسيح في كنيسته مَن يأتون إليه بتعبهم وثقل أحمالهم, والمسيح في كنيسته أيضاً يُشجّع الذين يعيشون في الخوف ويلقون الاضطهاد فقط لأنهم من أتباعه.
يحيا المسيح في كنيسته في قلوب الآلاف من المكرّسين الذين يعيشون معه في فرح عارم, وقد كرّسوا ذواتهم ليكونوا إلى جانب الفقير والمريض والمعذّب والمهمّش.
يعيش المسيح في كنيسته في كلّ من العائلات التي تعرف كيف تضحّي لتكون في وحدة معه, وأعضاؤها على اتّحاد فيما بينهم.
وفي كلّ هؤلاء يستمرّ المسيح حيّاً, وحياته فيهم هي شهادة للعالم على أنّه "الطريق والحقّ والحياة".
وما هذا كلّه إلا استجابة لصلاة يسوع من أجل "أن يأتي الملكوت, ويتقدّس اسم الآب, وتتمّ في الأرض مشيئته...".
ومع هذا كلّه, فالكنيسة ما ادّعت يوماً بأنّها كاملة في حياتها وفي تعاليمها وفي شهادتها. إنّها مُقدّسة لأنّ المسيح هو أساسها وهو حياتها, ولكنّ البشر الذين منهم تتألف هم باقون في ضعفهم وفي أنانيّتهم وفي صراعهم على المناصب أحياناً, تماماً كما كانت الحال مع ابني زبدى والآخرين. ويبقى أنّ انقساماتهم هي أكبر جرح ينزف عبر تاريخ الكنيسة, وهو يكوّن عثرة كبيرة لغير المؤمنين. ولا شكّ في أنّ هذه الحال هي التي دفعت بيسوع إلى صلاة توجّه فيها إلى أبيه في أواخر ساعات حياته, إذ قال: "أنا ذاهب إليك يا أبتِ القدّوس, إحفظهم باسمك الذي وهبته لي, ليكونوا واحداً كما نحن واحد... لا أدعو لهم وحدهم, بل أدعو أيضاً للذين سيؤمنون بي عن كلامهم. فليكونوا بأجمعهم واحداً... ليؤمن العالم بأنّك أنتَ أرسلتني...".
تبقى الإنقسامات في الكنيسة من أهمّ ما يشوّه صورة يسوع التي فيها, لذلك صلّى من أجل وِحدَة أبنائها, وهو ما انفكّ يدعوك ويدعوني, وهو يقرع على أبوابنا, كي نتابع الصلاة بكلّ ما أوتينا من صدق, ليمسح المسيحيّون للروح بأن يصالحهم.
فلا بُدّ لكنيسة المسيح من أن تختبر الجلجلة وتعيش على الصليب, تماماً كما فعل مؤسّسها. وهي ستعيش صراعات في الداخل وصراعات من الخارج. وكما كان للمسيح أن يسهر في بستان الزيتون ويعرق دماً... ويُكلّل بالشوك... ويُعلّق على الصليب, فهي أيضاً لا بُدّ وأن تمُرّ في جمّ من الآلام. ولكنّها تُدرك في ذلك كلّه أنّها ستستمرّ في حمل الرسالة, وأن سلطان الموت لن يقوى عليها.
سوف تتابع رسالتها متخطّية كلّ العقبات التي تعترضها, من الداخل أو الخارج. وفي أحلك ساعاتها وهي تظهر في أوج ضعف أبنائها, من كبيرهم إلى ضغيرهم, سيبقى الرجاء شعارها, ولن تسمح لنفسها بأن تقع في تجربة الخوف, ذلك لأنها تؤمن بأنّها مؤسسة على صخرة الله وأنّ يسوع "معها إلى منتهى الدهر". وهي تدرك, كما المعلّم, وجوب أن تمُرّ في الآلام والموت قبل أن تنبثق متجدّدة بروح قيامة سيّدها.
إنّ كلاًّ منّا مدعوّ إلى أن يعود إلى طريقة عيش يسوع محاولاً أن يعتنقها بقوّة في التأمّل والصلاة. لم يتكلّم يسوع في تعليمه على مؤسّسة بشريّة, بل تكلّم مراراً وتكراراً على ملكوت الله, وكأنّه ما شاء أن يقيّد عمله الفدائيّ, منذ البداية, في ما يشبه "التوراة والهيكل", وكأنّ في قصده أن يستبدلها أو ينقضها. ولو أنّه فعل, لَقَتَلَه اليهود في بدء رسالته.
أتى مخلّصاً إيّاهم والبشريّة جمعاء, وكان هو الذي بشّر به الأنبياء. بيد أنّ طول الزمن وانحراف الناس نحو ما يُرضي تطلّعاتهم البشريّة, جعلهم لا ينتظرون مخلّصا بحسب تعاليم الأنبياء وحسب, بل زعيماً سياسيّاً أو قائداً عسكريّاً يرفع عن كاهلهم نير الاحتلال, ويحمل إليهم التّقدّم والإزدهار.
فالتطويبات التي أطلقها يسوع من على الجبل في الجليل, والتي فيها نادى بالفقر والوداعة والرحمة, وأشاد بأولئك الذين يتقبّلون الآلام والاضطهادات على أنواعها, إنّما هي بعيدة كلّ البعد عن حقيقة المخلّص الذي كانوا يريدون.
وبعيداً كذلك عن آذانهم قوله إنّ الدخول في الملكوت, شأنه شأن الإنتماء إلى الكنيسة, يُحتّم على المرء أن يعيش في حال من الطهر والبساطة والثقة بالله, والتوكّل على محبّته اللامتناهية, والصفاء في محبّة الناس, ممّا يجعل في قلبه سلاماً يُشعره بأنّه يعيش في سماء, وهو ما زال في عِداد سكّان هذه الأرض. وأقرب مَنْ جسّدَ تلك الحال في ذهنه أطفال كان لهم في قلبه مقام خاصّ. ونحن نذكر أنّه, عندما أزعج ضجيج الأطفال التلاميذ يوماً, وظنّوا خطأً أنّ ذلك يُزعج المعلّم أيضاً, قال لهم: "دعوا الأطفال يأتون إليّ ولا تمنعوهم, لأنّ لمثل هؤلاء ملكوت السموات". ولكي يزيد في توضيح الأمر, قال لهم أيضاً: "إن لم تعودوا كالأطفال, لن تدخلوا ملكوت الله".
لكنّ يسوع المُخلّص ما أتى ليعمل إرادة الناس ولا ليرضي نزواتهم, بل لتتميم إرادة أبيه الذي في السماء. لِذا سار في نهجه, حتّى النهاية, مُهيّـئاً شيئاً فشيئاً, جماعة آمنت بمبادئه, تلك المبادئ التي ستتحوّل, مع الزمن, وبتوجيه من الروح, صخوراً صلبة تكوّن الأساس المتين لكنيسته. وكان يُدركُ آنذاك أنّ كنيسته سوف تمُرّ, كما في المؤسّسات جميعها, بالكثير من التجارب الصعبة, وتتحمّل الاضطهادات والآلام, وتكويها نيران الإنقسامات, وتتجاذبهاالإعتبارات البشريّة, ويُشوّه نقاءها أحياناً ما كان يخشاه عندما دعا تلاميذه إليه وقال لهم: "تعلمون أنّ رؤساء الأمم يسودونها, وأنّ أكابرها يتسلّطون عليها. فلا يكن هذا فيكم, بل مَن أراد أن يكون كبيراً فيكم, فليكن لكم خادماً. ومَن أراد أنْ يكون الأول فيكم, فليكن لكم عبداً. هكذا ابن الإنسان لم يأتِ ليُخدَم, بل ليَخدم ويفدي بنفسه جماعة الناس".
ولكن, إلى جانب ذلك كلّه, كان يُدركُ أيضاً أنّ أعداداً وافرة من أبناء كنيسته سيتميّزون بروح الخدمة تلك وسيبذلون حياتهم, كما فعل هو, ليشهدوا أمام الناس للنهج الذي عليه أسّس الكنيسة, ويسيروا في الطريق التي أخاطها لتلاميذه وأوضحها لهم بقوله: "مَن أراد أنّ يتبعني, فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني, لأنّ الذي يريد أن يُخلّص حياته يفقدها, وأمّا الذي يفقد حياته في سبيلي فيجدها".
في كنف القدّيسين والشهداء, وتحت أعباء ضعف الكنيسة وما يجرّ ذلك الضعف من شرور وويلات, تتابع الكنيسة مسيرتها بثقة, سائرة على خطى المعلّم في أكمال عمل الخلاص, لأنّه هو الذي يسير فيها ومعها, بحسب الوعد الذي قطعه لتلاميذه عندما أرسلهم ليُتلمذوا ويُعمّدوا قائلاً لهم: "هاأنذا معكم طوال الأيّام إلى نهاية العالم".
لقد كتب إرنست رينان, وهو طالما اشتهر بشكّه في أمور الدين, قائلاً: "يبدو المسيح اليوم, وبعد أن انقضى على مروره في هذه الدنيا مئات السنين, أنّ حبّه للعالم أصبح ألف مرّة أكثر وضوحاً عمّا كان في أثناء حياته على الأرض. لذلك فإنّ حبّ العالم له قد زاد آلاف الأضعاف منذ تلك الفترة. وقد غدا حقّاً حجر الزاوية للبشريّة بأسرها, حتّى ولو أنّه حدث أن زال ذكره في الدنيا, وزال معه كلّ ما ارتبط في شخصه, ليتزعزع الكون بأسره, حتّى عمق أعماق أساساته". وهذا بالطّبع أمر لا يُمكن لمُخيّلة أن تتصوّر حدوثه. فكفرناحوم باقية إلى ما لا نهاية, وكذلك أيضاً نائين وبيت عنيا والقبر الفارغ واللفائف التي غدت علامة الإنتصار على الموت إلى الأبد.
وسيكون هنالك دوماً مريض ينال الشفاء, وأعمى يعود إليه بصره, وإنسان أثقل كاهله الشعور بالذنب يحسّ بالغفران وينطلق في الحياة مجدّداً. وكلّ ذلك من خلال لمسة يد مُحِبّة ونظرة تفيض حناناً من ذلك القلب الذي أُفعِمَ حُبّاً لا يعرف أيّة حدود.
وهذه كلّها أشعّة ما زالت تتدفّق في ربوع عالمنا مُنبثقة من تلك المنارة التي عُمرها من عمر تاريخ البشر, والتي اكتمل الإشعاع فيها منذ ألفيّ سنة في يسوع المسيح المخلّص. وعندما "تُظلم الشمس, والقمر لا يُرسل ضوءه, وتتساقط النجوم من السماء...", ويؤخذ الناس على حين غفلة, عندما يحدث ذلك في يوم لا يعرفه أحد ولا الإبن إلا الآب, سيكون إشعاع ذلك النور أسطع من الشمس والقمر والنجوم مجتمعة.
فآخر إنسان في آخر يوم من عمر الكون, سينعمُ بدفء ذلك النور الذي أشرق في الظلمات, والظلمات لم تدركه". ولكن شرط أن يفتح ذلك الشخص قلبه للنور "ولا يُفضّل الظلام عليه". آنذاك يستنير سبيله. "أنا نور العالم, من يتبعني لا يمشِ في الظلام, بل يكون له نور الحياة".
سيأتي يوم يجد فيه كلّ منّا نفسه سالكاً تلك الطريق التي لا بدّ وأن يمرّ فيها كلّ إنسان. وآنذاك سيظهر ذاك "النور" على حقيقته, وهو جالسٌ على عرش مجده, سيّداً يُرحّبُ بالخراف الذين عن يمينه, ذلك لأنهم عرفوا كيف يرحّبوا هم بالجائع والعطشان والغريب, وقد اتّسع وقتهم وقلبهم للمريض وللمسجون ولكلّ مهمّش. وهُم فعلوا ذلك من دون أن يُدركوا أنّ في المريض والغريب والمُهمّش والمسجون يكمن ذاك الوجه المنير الذي يحسّ أنّك كلّما صنعت شيئاً لواحد من هؤلاء فله هو صنَعت ذلك, إذ إنّ كلاً منهم يحمل في عمق نفسه صورة لوجه الله, بل يحمل الله ذاته...
تعال الآن نعود معاً إلى كفرناحوم ونائين وبيت عنيا, حيث التقينا النور, بل مصدر كلّ نور وحياة. إنّ من جزم في نفسه أن يتقرّب من يسوع المسيح, ليتعرّف إليه عن كثب, إنّما يضع نفسه أمام تحدّ عظيم. والمهمّة التي انتقاها لنفسه لن تكون يوماً سهلة. ذلك أن يسوع المسيح ما وعد محبّيه يوماً إلا بصليب, عليهم أن يحملوه, وهو على مثال صليبه, لن يكون خفيفاً. بيد أنّه, كما وجد هو مَن يُساعده في حمل صليبه, سيرسل دوماً إلينا مَن يمُدّ يد العون في ساعات الشدّة.
والتّعرّف إلى المسيح يتطلّب, أول ما يتطلّب, أن أكرّس له ما يكفي من الوقت, فاقرأ الكتاب وأصغي في التأمل والصلاة, إلى ما يقوله لي الروح عن المسيح وعن ذاتي, وعن المعنى الذي يمكنني أن أعطيه حياتي.
الوقت الذي أمضيه في التأمّل والصلاة هو ما يجعلني أختبر قوّة الروح فيّ, وعمل الله في حياتي, وقتٌ لأقرأ وأصغي وأحبّ, فأحيا وأجد في الله راحة لنفسي.
كم هو مهمّ أن أعود بقلبي التعب إلى حضن المسيح, وأجلس معه على الجبل وهو يُكثِّرُ الخبز والسمك, لتكون لي قوّة فيه كما للجموع, وأن أقف وإيّاه على بئر يعقوب وأصغي إليه يحدّثني والسامريّة عن "الماء الحي". وكم هو حسنٌ أن أشارك لعازر ومرتا ومريم في فرحة الانبعاث والانطلاقة في الحياة مجدّداً.
وفوق كلّ شيء, عليّ أن أقف على أقدام الصليب, تلك الخشبة التي تمّ فداء الكون عليها, وأن أنتظر في البستان مع المجدليّة فجر القيامة. وأنت تقرأ هذه الفقرات, ها إنّ عقارب الساعة التي في معصمك, أو تلك المعلّقة على الحائط في بيتك, تتقدّم بانتظام, وعلى بابك يقف غريبٌ ويقرع, إنّه يحاول أن يدخل... وهو يُدركُ الآن أنّك تصغي.
إذا كان من المهمّ أن أتعرّف إلى المسيح من خلال ما كَتَبَت عنه الأناجيل, وما قال فيه الآباء والكنيسة, فمن المهمّ أيضاً أن ألتقيه اليوم حيث أعيش وأعمل. فملكوت الله جزء لا يتجزّأ في حياتي وعملي, بل هو "في داخلي". يُبنى الملكوت ويرتفع بقدر ما يعرف المرء كيف يعيش في شراكة حبّ فاعل مع المسيح ومع إخوته. وإنّ هذا لكنز ليس كالكنوز التي يجمعها الناس, والتي هي إلى فناء, وقد تُسرق منّا في أيّة لحظة. فالملكوت أشبه بكنز يتطلّب الاهتمام به جهداً مُكلفاً. فمًن وجَدَهُ لا بدّ وأن يضحّي بكلّ شيء كي يحافظ عليه وينمّيه, لأنّه أثمن من كلّ شيء.
"لا تكنزوا لأنفسكم كنوزاً في الأرض, حيث يفسد السوس والعثّ, وينقّب السارقون فيسرقون, بل اكنزوا لأنفسكم كنوزاً في السماء, حيث لا يفسد السوس والعثّ, ولا ينقّب السارقون فيسرقوا. فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك".
ها هو الملكوت فيما بيننا يدعونا إلى أن نحبّ ما هو أبعد, ونجهد في سبيل ما هو "أبقى" وأثمن. إنّه نعمة من الله وحياة. لقد كان دائماً وما زال يحتضن في طيّاته سرّ الحياة والموت, إذ إنّ فيه تأخذ الحياة, كما الموت, معناهما.
إنّ الملكوت حيّ في كلّ مدينة وفي كلّ قرية, بل وفي كلّ بيت ينبض الحبّ في قلوب ساكنيه. وهو قائم أيضاًفي قلبِ مَن لا بيت له ولا مأوى, إنّه النور الذي يخترق حياة الناس حتّى في أعمق أعماق بؤسها.
والملكوت يتخطّى الزمان والمكان, فحيث إنسان يحتضن المسيح في قلبه, وحيث بَشَر يسيرون على نهجه, وأناس يرقصون على أنغام موسيقاه, فهناك الملكوت.
لقد واجه يسوع الكثير من المصاعب والمضايقات وعدم الإيمان, حتى من أقرب المقرّبين إليه أحياناً. ولكنّه, بكلّ ثبات وطول أناة, راح يُعلّم ويشفي. وهكذا كان يبني كلّ يوم, حجراً فوق حجر, إلى أن غدا واضحاً أنّه أتى يؤسّس نهجاً جديداً, طريقة عيش جديدة, وهو يُعبّد طريقاً جديدة للخلاص. إنّه أتى ليُتمّم بناء الملكوت.
في البدء كان تصميم البناء أشبه بمخطّط يفتقر إلى الوضوح. فاليهود رأوا أنّ التوراة هي كلّ شيء, وأتى الكتبة والفرّيسيّون ففرضوا العمل بها بروح من الكبرياء جعلتهم يتمسّكون بالحرف ويهملون في الغالب ما في الجوهر. فأتى كلام يسوع إليهم غاية في القسوة, ناعتاً إيّاهم "بالقبور المكلّسة" و"بالحيّات أولاد الأفاعي..". وما كان بإمكانهم أن يتصوّروا أنّ ابن نجّار من الناصرة يمكن أن يكون المخلّص. لقد حسموا الأمر وأصدروا عليه وعلى كلّ من أبناء بلدته حكماً مسبقاً يقضي بألاّ "يخرج من الناصرة شيء صالح". لقد كانت قلوبهم من طينة غير التي جُبِلَ منها قلب تلك السامريّة التي كانوا بلا شكّ يحتقرونها, ولو أنّها من بنات قومهم لرجموها أقلّه خمس مرّات.
كانوا يحلمون بمخلص يليق بكبريائهم ويلبّي طموحاتهم, مخلّص سيفه ماضٍ, ورمحه ثاقب, وهو يحسن قيادة الجيوش الجرّارة التي ستعيد الحكم إلى إسرائيل. ونسوا ما قاله فيه أشعيا على أنّه سيكون ملك سلام لا ملك حرب, وفي عهده "سيربض الذئب مع الحمل...".
ما كان بإمكانهم أن يقبلوا مسيحاً فقيراً, أتى "ليَخدِم لا ليُخدَم", "يأكل مع العشارين والخطأة", يوصي مَن يصغون إليه بأنّ "أحبّوا أعداءكم, وأحسنوا إلى مبغضيكم, وباركوا لاعنيكم, وصلّوا من أجل المفترين الكذب عليكم. مَن ضربكَ على خدّكَ فاعرض له الآخر...".
ويسوع ما بدأ عمله بخلق مؤسّسة ذات تنظيم محكم, لها أركانها وفروعها وأنظمتها, بل بدأ عمله مع حفنة من الرجال, ليسوا من كبار هذا العالم, ولا هم في نظر الناس, من طبقة مميّزة. وقال بولس فيهم إنّ الله اختار الجهّال والضعفاء ومَن شابههم, لكي يُدرك الجميع أنّ بناء الملكوت إنّما هو عمل الله قبل أن يكون نتيجة لجهد بشر, وهو يبدأ متواضعاً ويكبر. هذا يذكّرنا به مَثَل حبّة الخردل حيث قال: "مثل ملكوت السموات كَمَثل حبّة خردل, أخذها رجل فزرعها في حقله, وهي أصغر البذور كلّها, فإذا نَمَت كانت أكبر البقول, بل صارت شجرة حتّى أنّ طيور السماء تأتي فتعشعش في أغصانها".
لقد نما الملكوت شيئاً فشيئاً وكان العاملون في بنائه أشبه بالخمير في العجين, والكنز المخبّأ في حقل. وكأنّ يسوع أراد أن يسير في عمله بتواضع وبشيء من الصمت, لأنّ أهمّ ما في الأمر التطور الداخلي عند الذين التزموا به, بعيداً عن المظاهر والشكليّات, معلناً أنّه "يريد رحمةً لا ذبيحة, وأنّ السبت خُلِقَ للإنسان, لا الإنسان للسبت...".
وهكذا ببطء, ولكن بعمق, كان الملكوت يُبنى وتمتدّ أشعّته فتنتشر أحيانا وتنحسر أحيانا أخرى, حتّى أنّه, عندما صُلب يسوع بدا لبعضهم وكأنّه لا يتعدّى كونه شيعة من الشيع التي سوف تندثر بموت صاحبها.
والواقع أنّ الأمور سوف تتبدّل تماماً ولكن في اتجاه آخر. ذلك أنّ الجلجلة, بَدَلَ أن تكون النهاية, غدت مدخل عهد شفى جرح آدم الأول, وشرّع أمام البشريّة أبواب السماء مجدّداً.
ولكي يكتمل عمل الخلاص بين الناس, كان من الضروريّ أن يستمرّ حضور المسيح القائم من الموت في إطار يمكّن أولئكَ الذين تتلمذوا على يده, وشهدوا على حقيقة قيامته, من أن يُتابعوا العمل باسمه. لقد شاء أن يستمرّ حضوره معهم من خلال ما أعطاهم في الليلة التي أُسلم فيها, وقد أعطاهم ذاته ليكون لهم خبز حياة, يبقى معهم "حتّى انتهاء العالم". ذلك لأنّه أرادهم, وكلّ مَن سيؤمنون على أيديهم, أن يُعلنوا باسمه "التوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم, ابتداء من أورشليم", كما أرادهم أن يكونوا "شهوداً على تلك الأمور...". ولكي يقووا على إكمال المسيرة قال لهم: "إنّي أرسل إليكم ما وعد به أبي. فامكثوا أنتم في المدينة إلى أن تلبسوا قوّة من العلى". وهكذا فعلوا وحلّ الروح القدس عليهم, إذ "كانوا كلّهم مجتمعين في مكان واحد, فانطلق من السماء بغتة دويّ كريح عاصفة, فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه, وظهرت ألسنة كأنها من نار قد انقسمت, فوقفت على كلّ منهم, وامتلأوا جميعاً من الروح القدس, وأخذوا يتكلّمون بلغات غير لغتهم, على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلّموا". وإذا كان لنا أن نبحث عن حدث الروح القدس يكون هو الحدث.
عندما تبدأ المؤسّسة تظهر إلى العيان في جماعة بشريّة, يُصبح من الضروريّ أن يُقام تنظيم لتلك الجماعة. ولا بُدّ أنّ التلاميذ وبطرس, وهم في العنصرة, تذكّروا المشهد التالي الذي حدث في نواحي قيصريّة فيلبّس حيث "سأل يسوع تلاميذه: مَن يكون ابن الإنسان في قول الناس؟...", وبعد أن أجابوا طرح عليهم السؤال بشكل شخصيّ قائلا: "مَن أنا في قولكم أنتم ؟", فأجاب سمعان بطرس: "أنت المسيح ابن الله الحيّ".
وبعد شهادة بطرس هذه بلاهوت يسوع, وذلك بوحي مِن لدن الآب السماويّ, قال له يسوع بكلّ وضوح ما لم يقله لسواه من التلاميذ: "أنا أقول لك: أنت صخر وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي, فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. كلّ ما تربطه في الأرض يُربط في السموات, وما تحلّه في الأرض يُحلّ في السموات".
يرمز الصخر إلى الصلابة والثبات, وهذا لقب بطرس منذ ذلك الحين.
وتشير الكنيسة إلى الجماعة الجديدة التي أسّسها يسوع وجعل بطرس رمز الثبات فيها, وعهد إليه بدور رفيع في السهر على انطلاقتها. ومن ضمن هذا الدور قبول الناس في الجماعة أو عدم قبولهم, وتفسير كلام يسوع على حقيقته. وهذه السلطة لم يحصرها ببطرس, بل أعطاها أيضا إلى سائر التلاميذ معه, ولو كانت له الأولويّة عليهم.
فها هي الجماعة تبدأ بالظهور وكأنّ لها بداية بُنية تنظيميّة مُرتكزة على بطرس والأحد عشر. لذا نراهم, بعد حلول الروح القدس مباشرة, يقفون معاً, ونرى بطرس يتكلّم باسمهم بوضوح, وكمَن له سلطان: "فوقف بطرس مع الأحد عشر, فرفع صوته وكلّم الناس قائلا: يا رجال اليهوديّة, وأنتم أيّها المقيمون في أورشليم جميعاً, اعلموا هذا, واصغوا...". وراح يُذكّرهم بما تنبّأ به النبيّ يوئيل عمّا يتحقّق الآن... تمّ انتقل إلى الكلام على "بني إسرائيل" جميعاً فذكّرهم أيضاً بموت يسوع وقيامته, موضحاً لهم أنّ ما حدث كان قد تنبّأ به النبيّ داود من قبل أيضاً.
سيحيا هذا الحدث إلى ما لا نهاية في الكنيسة. ومشاركة الإنسان لله في حياته, هي التي تُحيي الإنسان المؤمن من خلال الكنيسة. ومن خلال الكنيسة أيضاً سيحصل الأنسان على الغفران حين يفشل في العمل مع الله لبناء ملكوته. فعطاءات الله للإنسان لا تُقدّر, بل توصف "بالحياة الوافرة", بيد أنّه على الإنسان أن يُقبل على ذلك النبع ليستقي منه القدرة وملء الحياة, والغفران أيضاً.
تفيض الحياة من قلب الله, ولكنّ الإنسان لا يتلقّاها من فراغ, من الهواء الذي يُحيط به, ولا من أمور نتصوّر وجودها في مخيّلتنا, بل يستقيها من خلال أقنية محدّدة تمرّ كلّها في يسوع المسيح الذي هو صورة الله وقدرته الفائقة.
وهو ما تحاول الكنيسة أن تجسّده في واقعها وفي سلوكها, جاهدة في أن تدعه يملكها كجماعة من دون أن تملكه هي وتستأثر به.
يتعامل الله معنا, بل يعمل فينا, من خلال واقعنا كبشر. وسرّ نفسيّتي كإنسان ليس بسرّ عليه. فحقيقة المسيح, كما حاجات البشر, بل حياتهم بأكملها, هي من العوامل التي يمكن أن تُبيّن لنا هدف يسوع من تأسيس كنيسة ليحقّق من خلالها ملكوت أبيه في العالم.
يسوع, ذاك الغريب الذي يقرع بابك وبابي وكلّ باب في الدنيا, أتى ليعايش مَن يُقرّر أن يفتح له بابه, ويوضح له حقيقة حضور الله في حياته, ذلك الحضور الذي تجسّد في حدث الخلاص, من ولادة المسيح إلى قيامته, والذي سوف يتجسّد في حياة كلّ مَن يصغي إليه ويقبله فادياً ومخلّصاً.
هذا الحضور نفسه, تحاول الكنيسة أن تجسّده بدورها. وشاء يسوع أن يتماهى معها بعد أن أوحى إليها حيقته في تعاليمه. وهو يجدّد حضوره فيها من خلال لقاءاته المتكرّرة في علامات حسّية ترافقنا في مراحل حياتنا كافّة, وتسمّيها الكنيسة "أسراراً".
وتعاليم يسوع تلك التي أعطاها تلاميذه أرادها أن تنتشر من خلالهم في العالم كلّه. فبعدما قام من الموت وراح يتراءى لهم الواحد تلوَ الآخر, أفراداً وجماعات, قال لهم: "إذهبوا في العالم كلّه, واعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين...". وأعطاهم أيضاً, مع كلمته, مواهب الشفاء. فهو أرادهم أن يسلكوا, كما سلك هو في حياته, مُحقّقاً رسالته المزدوجة, رسالة التعليم ورسالة الشفاء, فهو من أجل ذلك أتى إلى العالم متجسّداً.
لذا كان من الطبيعيّ, لمّا راحت الكنيسة تنتشر في أماكن بعيدة, أن يبدأ العارفون بتلك الأمور بكتابة ولو بعض منها, بوحي من الروح القدس.
وهكذا تكوّن, بعد عشرات السنين على موته, ما نسمّيه اليوم بالأناجيل الأربعة التي هي لمتّى ومرقس ولوقا ويوحنّا.
ولكن هذه الكتب هي, منذ ذلك الحين, في عُهدة الكنيسة التي هي أمّ ومعلّمة. فهي تشرحها وتوضح ما قد يصعب فهمه فيها. فالكنيسة هي التي تسلّمت من يسوع رسالة التعليم, ولم تتسلّم منه أيّة نصوص مكتوبة. لقد شاء أن تكون الكنيسة امتداداً لشخصه ولرسالته. وهكذا يمكننا أن نفهم السؤال الذي وجّهه إلى شاول عندما التقاه وهو في طريقه إلى دمشق قاصداً إعتقال أتباع يسوع وسوقهم إلى أورشليم: "شاول شاول, لماذا تضطهدني ؟".
ولأنّ يسوع أراد الكنيسة امتداداً لشخصه ولرسالته, بل جسده السّريّ, تؤمن الكنيسة بأنّ الروح يعضد ضعفها دوماً ويُنير طريقها لأنّها منذ البداية سمعت صوت المعلّم وما زالت تسير على هديه: "كما أرسلني الآب... هكذا أنا أرسلكم".
أرسلهم, ولكنّه كان يُدرك أنّه قد "اختار مَن هم ضعفاء ليخزي الأقوياء". إثنا عشر رجلاً دعاهم وأرسلهم ليحملوا الرسالة إلى العالم كلّه, ووعدهم بأن يكون دوماً إلى جانبهم في عملهم.
ولكن, لا ننسَ أنّ هؤلاء كانوا بشراً متسربلين بالضعف ككل البشر, ولكنّ قوّتهم هي في الذي أرسلهم والذي يعيش معهم وفيهم.
وإذا كان المسيح حيّاً في كنيسته اليوم وهو الله, إذا يمكن الكنيسة أن تدّعي بأن الله ليس في أساسها وحسب, بل هو أيضاً في تاريخها, في كلّ مسيرتها التاريخيّة. لا تبعد الكنيسة عن المسيح مسافة ألفي سنة, لأنّه ما فارقها يوماً, لأنّها هي تجسّد له, وهي تفقد هويّتها إذا ما غُيّب المسيح عنها.
لذلك يقال عن الكنيسة أنّها مقدّسة وإنّ نموّها لا يخضع لقوانين بشريّة... والمسيح الحيّ في كنيسته يجترح العجائب كلّ يوم في نفوس الناس, معزّياً بعضهم ومشجّعاً بعضهم الآخر, ومضرماً الحبّ في قلوب آخرين, الذين يقولون مع بولس: "إنّ حُبّ الله هو الذي يدفع بي إلى الأمام".
يُريح المسيح في كنيسته مَن يأتون إليه بتعبهم وثقل أحمالهم, والمسيح في كنيسته أيضاً يُشجّع الذين يعيشون في الخوف ويلقون الاضطهاد فقط لأنهم من أتباعه.
يحيا المسيح في كنيسته في قلوب الآلاف من المكرّسين الذين يعيشون معه في فرح عارم, وقد كرّسوا ذواتهم ليكونوا إلى جانب الفقير والمريض والمعذّب والمهمّش.
يعيش المسيح في كنيسته في كلّ من العائلات التي تعرف كيف تضحّي لتكون في وحدة معه, وأعضاؤها على اتّحاد فيما بينهم.
وفي كلّ هؤلاء يستمرّ المسيح حيّاً, وحياته فيهم هي شهادة للعالم على أنّه "الطريق والحقّ والحياة".
وما هذا كلّه إلا استجابة لصلاة يسوع من أجل "أن يأتي الملكوت, ويتقدّس اسم الآب, وتتمّ في الأرض مشيئته...".
ومع هذا كلّه, فالكنيسة ما ادّعت يوماً بأنّها كاملة في حياتها وفي تعاليمها وفي شهادتها. إنّها مُقدّسة لأنّ المسيح هو أساسها وهو حياتها, ولكنّ البشر الذين منهم تتألف هم باقون في ضعفهم وفي أنانيّتهم وفي صراعهم على المناصب أحياناً, تماماً كما كانت الحال مع ابني زبدى والآخرين. ويبقى أنّ انقساماتهم هي أكبر جرح ينزف عبر تاريخ الكنيسة, وهو يكوّن عثرة كبيرة لغير المؤمنين. ولا شكّ في أنّ هذه الحال هي التي دفعت بيسوع إلى صلاة توجّه فيها إلى أبيه في أواخر ساعات حياته, إذ قال: "أنا ذاهب إليك يا أبتِ القدّوس, إحفظهم باسمك الذي وهبته لي, ليكونوا واحداً كما نحن واحد... لا أدعو لهم وحدهم, بل أدعو أيضاً للذين سيؤمنون بي عن كلامهم. فليكونوا بأجمعهم واحداً... ليؤمن العالم بأنّك أنتَ أرسلتني...".
تبقى الإنقسامات في الكنيسة من أهمّ ما يشوّه صورة يسوع التي فيها, لذلك صلّى من أجل وِحدَة أبنائها, وهو ما انفكّ يدعوك ويدعوني, وهو يقرع على أبوابنا, كي نتابع الصلاة بكلّ ما أوتينا من صدق, ليمسح المسيحيّون للروح بأن يصالحهم.
فلا بُدّ لكنيسة المسيح من أن تختبر الجلجلة وتعيش على الصليب, تماماً كما فعل مؤسّسها. وهي ستعيش صراعات في الداخل وصراعات من الخارج. وكما كان للمسيح أن يسهر في بستان الزيتون ويعرق دماً... ويُكلّل بالشوك... ويُعلّق على الصليب, فهي أيضاً لا بُدّ وأن تمُرّ في جمّ من الآلام. ولكنّها تُدرك في ذلك كلّه أنّها ستستمرّ في حمل الرسالة, وأن سلطان الموت لن يقوى عليها.
سوف تتابع رسالتها متخطّية كلّ العقبات التي تعترضها, من الداخل أو الخارج. وفي أحلك ساعاتها وهي تظهر في أوج ضعف أبنائها, من كبيرهم إلى ضغيرهم, سيبقى الرجاء شعارها, ولن تسمح لنفسها بأن تقع في تجربة الخوف, ذلك لأنها تؤمن بأنّها مؤسسة على صخرة الله وأنّ يسوع "معها إلى منتهى الدهر". وهي تدرك, كما المعلّم, وجوب أن تمُرّ في الآلام والموت قبل أن تنبثق متجدّدة بروح قيامة سيّدها.

ندى الور- مساعد المشرف العام
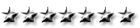
- عدد المساهمات : 2691
نقاط : 7825
تاريخ التسجيل : 02/05/2009
العمر : 47
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» لقد اقترب ملكوت السماوات
» تذكار تدشين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس في روما / 18 تشرين الثاني.
» تذكار إختياريّ لتدشين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس في رومة / 18 تشرين الثاني.
» تذكار تدشين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس في روما / 18 تشرين الثاني.
» تذكار إختياريّ لتدشين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس في رومة / 18 تشرين الثاني.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى